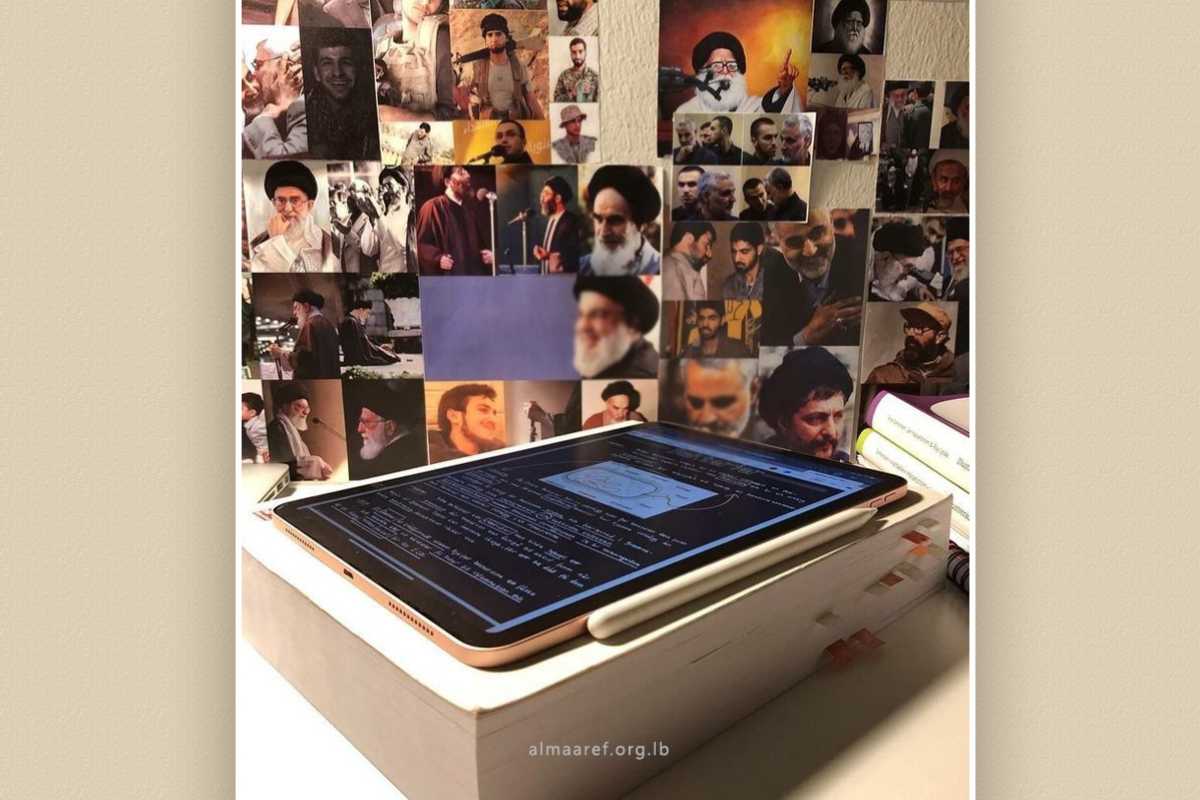الحرية والمجتمع الإسلامي
المجتمع الإسلامي
كلمة الحرية على ما يراد بها من المعنى لا يتجاوز عمرها في دورانها على الألسن عدة قرون ولعل السبب المبتدع لها هي النهضة المدنية الأوروبية قبل بضعة قرون لكن معناها كان يجول في الأذهان وأمنية من أماني القلوب منذ عصور قديمة...
عدد الزوار: 16
كلمة الحرية على ما يراد بها من المعنى لا يتجاوز عمرها في دورانها على الألسن عدة قرون ولعل السبب المبتدع لها هي النهضة المدنية الأوروبية قبل بضعة قرون لكن معناها كان يجول في الأذهان وأمنية من أماني القلوب منذ عصور قديمة.
والأصل الطبيعي التكويني الذي ينتشي منه هذا المعنى هو ما تجهز به الإنسان في وجوده من الإرادة الباعثة إياه على العمل فإنها حالة نفسية في إبطالها إبطال الحس والشعور المنجر إلى إبطال الإنسانية.
غير أن الإنسان لما كان موجوداً اجتماعياً تسوقه طبيعته إلى الحياة في المجتمع وإلقاء دلوه في الدلاء بإدخال إرادته في الإرادات، وفعله في الأفعال المنجر إلى الخضوع لقانون يعدّل الإرادات والأعمال بوضع حدود لها فالطبيعة التي أعطته إطلاق الإرادة والعمل هي بعينها تحدد الإرادة والعمل وتقيد ذلك الإطلاق الابتدائي والحرية الأولية.
والقوانين المدنية الحاضرة لما وضعت بناء أحكامها على أساس التمتع المادي أنتج ذلك حرية الأمة في أمر المعارف الأصلية الدينية من حيث الإلتزام بها وبلوازمها، وفي أمر الأخلاق، وفي ما وراء القوانين من كل ما يريده ويختاره الإنسان من الإرادات والأعمال فهذا هو المراد بالحرية عندهم.
وأما الإسلام فقد وضع قانونه على أساس التوحيد ثم في المرتبة التالية على أساس الأخلاق الفاضلة ثم تعرضت لكل يسير وخطير من الأعمال الفردية والاجتماعية كائنة ما كانت فلا شيء مما يتعلق بالإنسان أو يتعلق به الإنسان إلا وللشرع الإسلامي فيه قدم أو أثر قدم فلا مجال ولا مظهر للحرية بالمعنى المتقدم فيه.
نعم للإنسان فيه الحرية عن قيد عبودية غير الله سبحانه وهذا وإن كان لا يزيد على جملة واحدة غير أنه وسيع المعنى عند من بحث بصورة عميقة في السنة الإسلامية، والسيرة العملية التي تندب إليها وتقرها بين أفراد المجتمع وطبقاته ثم قاس ذلك إلى ما يشاهد من سنن السؤدد والسيادة والتحكمات في المجتمعات المتمدنة بين طبقاتها وأفرادها أنفسها وبين كل أمة قوية وضعيفة.
وأما من حيث الأحكام فالتوسعة فيما أباحه الله من طيبات الرزق ومزايا الحياة المعتدلة من غير إفراط أو تفريط قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾1.
وقال تعالى: ﴿خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً﴾2.
وقال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾3.
ومن عجيب الأمر ما رامه بعض الباحثين والمفسرين، وتكلف فيه من إثبات حرية العقيدة في الإسلام بقوله تعالى: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾4 وما يشابهه من الآيات الكريمة.
إن التوحيد أساس جميع النواميس الإسلامية ومع ذلك كيف يمكن أن يشرع حرية العقائد ؟ وهل ذلك إلا التناقض الصريح ؟ فليس القول بحرية العقيدة إلا كالقول بالحرية عن حكومة القانون في القوانين المدنية بعينه.
وبعبارة أخرى العقيدة بمعنى حصول إدراك تصديقي ينعقد في ذهن الإنسان ليس عملاً اختيارياً للإنسان حتى يتعلق به منع أو تجويز أو استعباد أو تحرير، وإنما الذي يقبل الحظر والإباحة هو الإلتزام بما تستوجبه العقيدة من الأعمال كالدعوة إلى العقيدة وإقناع الناس بها وكتابتها ونشرها وإفساد ما عند الناس من العقيدة، والعمل المخالف لها ؛ فهذه هي التي تقبل المنع والجواز، ومن المعلوم أنها إذا خالفت مواد قانون دائر في المجتمع أو الأصل الذي يتكي عليه القانون لم يكن مناص من منعها من قبل القانون ولم يتكِ الإسلام في تشريعه على غير دين التوحيد (التوحيد والنبوة والمعاد) وهو الذي يجتمع عليه المسلمون واليهود والنصارى والمجوس (أهل الكتاب) فليست الحرية إلا فيها وليست فيما عداها إلا هدفاً لأصل الدين ؛ نعم هاهنا حرية أخرى وهي الحرية من حيث إظهار العقيدة.
التكامل في المجتمع الإسلامي
ربما أمكن أن يقال: هب أن السنة الإسلامية سنة جامعة للوازم الحياة السعيدة، والمجتمع الإسلامي مجتمع سعيد مغبوط لكن هذه السنة لجامعيتها وانتفاء حرية العقيدة فيها تستوجب ركود المجتمع ووقوفه عن التحول والتكامل وهو من عيوب المجتمع الكامل كما قيل فإن السير التكاملي يحتاج إلى تحقيق القوى المتضادة في الشيء وتفاعلها حتى تولد بالكسر والانكسار مولوداً جديداً خالياً من نواقص العوامل المولدة التي زالت بالتفاعل فإذا فرض أن الإسلام يرفع الأضداد والنواقص وخاصة العقائد المتضادة من أصلها فلازمه أن يتوقف المجتمع الذي يكونه عن السير التكاملي.
أقول: وهو من إشكالات المادية الجدلية (ديالكتيك) وفيه خلط عجيب فإن العقائد والمعارف الإنسانية على نوعين نوع يقبل التحول والتكامل وهو العلوم الصناعية التي تستخدم في طريق ترفيع قواعد الحياة المادية وتذليل الطبيعة العاصية للإنسان كالعلوم الرياضية والطبيعية وغيرهما، وهذه العلوم والصناعات وما في عدادها كلما تحولت من النقص إلى الكمال أوجب ذلك تحول الحياة الاجتماعية لذلك.
ونوع آخر لا يقبل التحوّل وإن كان يقبل التكامل بمعنى آخر وهو العلوم والمعارف العامة الإلهية التي تقضي في المبدأ والمعاد والسعادة والشقاء وغير ذلك قضاءً قاطعاً واقفاً غير متغير ولا متحول وإن قبلت الارتقاء والكمال من حيث الدقة والتعمق وهذه العلوم والمعارف لا تؤثر في الاجتماعات وسنن الحياة إلا بنحو كلي، فوقوف هذه المعارف والآراء وثبوتها على حال واحد لا يوجب وقوف الاجتماعات عن سيرها الارتقائي كما نشاهد أن عندنا آراء كثيرة كلية ثابتة في حال واحد من غير أن يقف اجتماعنا لذلك عن سيره كقولنا: إن الإنسان يجب أن ينبعث إلى العمل لحفظ حياته وإن العمل يجب أن يكون لنفع عائد إلى الإنسان، وإن الإنسان يجب أن يعيش في حال الاجتماع (التجمع) وقولنا: إن العالم موجود حقيقة لا وهما وإن الإنسان جزء من العالم، وإن الإنسان جزء من العالم الأرضي، وان الإنسان ذو أعضاء وأدوات وقوى إلى غير ذلك من الآراء والمعلومات الثابتة التي لا يوجب ثبوتها ووقوفها وقوف المجتمعات وركودها، ومن هذا القبيل القول بأن للعالم إلهاً واحداً شرع للناس شرعاً جامعاً لطرق السعادة من طريق النبوة وسيجمع الجميع إلى يوم يوفيهم فيه جزاء أعمالهم، وهذه هي الكلمة الوحيدة التي بنى عليها الإسلام مجتمعه وتحفظ عليها كل التحفظ، ومن المعلوم أنه مما لا يوجب باصطكاك ثبوته ونفيه وإنتاج رأي آخر فيه إلا انحطاط المجتمع،وهذا شأن جميع الحقائق الحقة المتعلقة بما وراء الطبيعة فإنكارها بأي وجه لا يفيد المجتمع إلا انحطاطاً وخسة.
والحاصل: أن المجتمع البشري لا يحتاج في سيره الارتقائي إلا إلى التحول والتكامل يوماً فيوماً في طريق الاستفادة من مزايا الطبيعة، وهذا إنما يتحقق بالبحث الصناعي المداوم وتطبيق العمل على العلم دائماً والإسلام لا يمنع من ذلك شيئاً.
وأما تغير طريق إدارة المجتمعات وسنن الاجتماع الجارية كالاستبداد الملوكي والديموقراطية والشيوعية، ونحوها فليس بلازم إلا من جهة نقصها وقصورها عن إيفاء الكمال الإنساني الاجتماعي المطلوب لا من جهة سيرها من النقص إلى الكمال فالفرق بينها لو كان فإنما هو فرق الغلط والصواب لا فرق الناقص والكامل فإذا استقر أمر السنة الاجتماعية على ما يقصده الإنسان بفطرته وهو العدالة الاجتماعية واستظل الناس تحت التربية الجيدة بالعلم النافع والعمل الصالح ثم أخذوا يسيرون مرتاحين ناشطين نحو سعادتهم بالارتقاء في مدارج العلم والعمل ولا يزالون يتكاملون ويزيدون تمكناً واتساعاً في السعادة فما حاجتهم إلى تحول السنة الاجتماعية زائداً على ذلك ؟ ومجرد وجوب التحول على الإنسان من كل جهة حتى فيما لا يحتاج فيه إلى التحوّل مما لا ينبغي أن يقضي به ذو نظر وبصيرة.
فإن قلت: لا مناص من عروض التحوّل في جميع ما ذكرت، أنه مستغن عنه كالاعتقادات والأخلاق الكلية ونحوها فإنها جميعاً تتغير بتغير الأوضاع الاجتماعية والمحيطات المختلفة، ومرور الأزمنة، فلا يجوز أن ينكر أن الإنسان الجديد تغاير أفكاره أفكار الإنسان القديم، وكذا الإنسان يختلف نحو تفكره بحسب اختلاف مناطق حياته كالأراضي الاستوائية والقطبية، والنقاط المعتدلة، وكذا بتفاوت أوضاع حياته من خادم ومخدوم وبدوي وحضري ومثر ومعدم، وفقير وغني، ونحو ذلك فالأفكار والآراء تختلف باختلاف العوامل وتتحول بتحول العصور بلا شك كائنة ما كانت.
قلت: الإشكال مبني على نظرية نسبية العلوم والآراء الإنسانية، ولازمها كون الحق والباطل والخير والشر أموراً نسبية إضافية فالمعارف الكلية النظرية المتعلقة بالمبدأ والمعاد وكذا الآراء الكلية العملية كالحكم بكون الاجتماع خيراً للإنسان، وكون العدل خيراً (حكماً كلياً لا من حيث انطباقه على المورد) تكون أحكاماً نسبية متغيرة بتغير الأزمنة والأوضاع، والأحوال،لكن هذه النظرية فاسدة من حيث كليتها.
وحاصل فسادها: أن النظرية غير شاملة للقضايا الكلية النظرية وقسم من الآراء الكلية العملية.
وكفى في بطلان كليتها أنها لو صحت ( أي كانت كلية ـ مطلقة ـ ثابتة) أثبتت قضية مطلقة غير نسبية وهي نفسها، ولو لم تكن كلية مطلقة، بل قضية جزئية أثبتت بالاستلزام قضية كلية مطلقة فكليتها باطلة على أي حال.
وبعبارة أخرى: لو صح أن "كل رأي واعتقاد يجب أن يتغير يوماً" وجب أن يتغير هذا الرأي نفسه.
هل الإسلام قادر على إسعاد البشرية؟
ربما يقال: هب أن الإسلام لتعرضه لجميع شؤون الإنسانية الموجودة في عصر نزول القرآن كان يكفي في إيصاله مجتمع ذلك العصر إلى سعادتهم الحقيقية، وجميع أمانيهم في الحياة لكن الزمن استطاع أن يغير طرق الحياة الإنسانية، فالحياة الثقافية والعيشة الصناعية في حضارة اليوم لا تشبه الحياة الساذجة قبل أربعة عشر قرناً المقتصرة على الوسائل الطبيعية الابتدائية، فقد بلغ الإنسان إثر مجاهداته الطويلة الشاقة مبلغاً من الارتقاء والتكامل المدني لو قيس إلى ما كان عليه قبل عدة قرون كان كالقياس بين نوعين متباينين فكيف تفي القوانين الموضوعة لتنظيم الحياة في ذلك العصر للحياة المتشكلة العبقرية اليوم؟ وكيف يمكن أن تحمل كل من الحياتين أثقال الأخرى؟
والجواب: أن الاختلاف بين العصرين من حيث صورة الحياة لا يرجع إلى كليات شؤونها، وإنما هو من حيث المصاديق والموارد وبعبارة أخرى يحتاج الإنسان في حياته إلى غذاء يتغذى به، ولباس يلبسه، ودار يقطن فيه ويسكنه، ووسائل تحمله وتحمل أثقاله وتنقلها من مكان إلى آخر ومجتمع يعيش بين أفراده، وروابط تناسلية وتجارية وصناعية وعملية وغير ذلك، وهذه حاجة كلية غير متغيرة ما دام الإنسان إنساناً يحمل نفس الفطرة والبنية، وما دام حياته هذه الحياة الإنسانية والإنسان الأولي وإنسان هذا اليوم في ذلك على حد سواء.
وإنما الاختلاف بينهما من حيث مصاديق الوسائل التي يرفع الإنسان بها حوائجه المادية، ومن حيث مصاديق الحوائج حسب ما يتنبه لها وبوسائل رفعها.
فقد كان الإنسان الأولي مثلاً يتغذى بما يجده من الفواكه والنبات ولحم الصيد على وجه بسيط ساذج، وهو اليوم يهيىء منها ببراعته وابتداعه ألوفاً من ألوان الطعام والشراب ذات خواص تستفيد منها طبيعته، وألوان يستلذ منها بصره، وطعوم يستطيبها ذوقه، وكيفيات يتنعم بها لمسه، وأوضاع وأحوال أخرى يصعب إحصاؤها، وهذا الاختلاف الفاحش لا يفرق الثاني من الأول من حيث ان الجميع غذاء يتغذى به الإنسان لسد جوعه وإطفاء نائرة شهوته. وكما أن هذه الاعتقادات الكلية التي كانت عند الإنسان أولاً لم تبطل بعد تحوله من عصر إلى عصر بل انطبق الأول على الآخر انطباقاً، كذلك القوانين الكلية الموضوعة في الإسلام طبق دعوة الفطرة واستدعاء السعادة لا تبطل بظهور وسيلة مكان وسيلة ما دام الوفاق مع أصل الفطرة محفوظاً من غير تغير وانحراف، وأما مع المخالفة فالسنة الإسلامية لا توافقها سواء في ذلك العصر القديم، والعصر الحديث.
وأما الأحكام الجزئية المتعلقة بالحوادث الجارية التي تحدث زماناً وزماناً وتتغير سريعاً بالطبع كالأحكام المالية والانتظامية المتعلقة بالدفاع وطرق تسهيل الارتباطات والمواصلات والمؤسسات البلدية ونحوها فهي مفوضة إلى اختيار الوالي ومتصدي أمر الحكومة فإن الوالي نسبته إلى ساحة ولايته كنسبة الرجل إلى بيته فله أن يعزم على أمور من شؤون المجتمع في داخله أو خارجه مما يتعلق بالحرب أو السلم مالية أو غير مالية يراعي فيها صلاح حال المجتمع بعد المشاورة مع المسلمين كما قال تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ﴾5 كل ذلك من الأمور العامة.
وهذه أحكام وقواعد جزئية تتغير بتغير المصالح والأسباب التي لا تزال يحدث منها شيء ويزول منها شيء غير الأحكام الإلهية التي يشتمل عليها الكتاب والسنة ولا سبيل للنسخ إليها.
*قضايا المجتمع والأسرة والزواج على ضوء القرآن الكريم، العلامة السيد محمد حسين الطبطبائي، دار الصفوة، ص40-48.
1- الأعراف:32.
2- البقرة:29.
3- الجاثية:13.
4- البقرة: 256.
5- آل عمران: 159