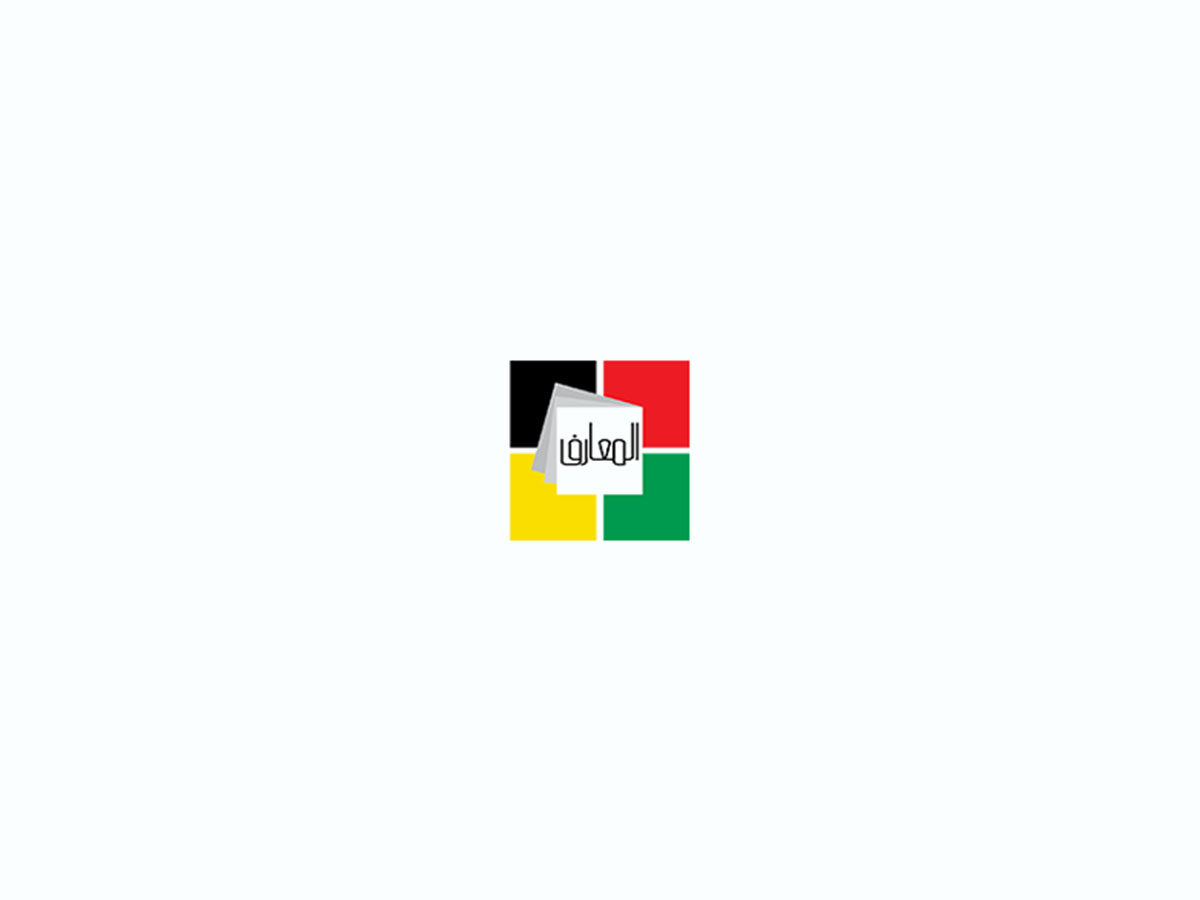أهمية العلم في الإسلام ومنهج الاستنهاض عند الإمام الخميني قدس سره
الجامعة في فكر الإمام
القضية الأساس التي تواجه الإنسان منذ فجر التاريخ هي محاولته الدائبة لسبر أغوار نفسه، وعلاقته بالوجود لناحية دوره وغايته فضلاً عن علاقته بمحيطه الاجتماعي.
عدد الزوار: 769
تمهيد
القضية الأساس التي تواجه الإنسان منذ فجر التاريخ هي محاولته الدائبة لسبر أغوار
نفسه، وعلاقته بالوجود لناحية دوره وغايته فضلاً عن علاقته بمحيطه الاجتماعي.
هذه المحاولات لم تكن سوى وليدة الدافع المعرفي الذي استودعه الباري في طبيعة
الإنسان خلافاً لغيره من المخلوقات التي كرمه ورفعه فوقها من خلال العقل، والذي من
خلاله استحق الإنسان أن يكون خليفة لله في الأرض. ولم يترك الله الإنسان وحده في
معركة الاستخلاف وإثبات جدارته في هذا الوجود، فرفده بالأنبياء والرسالات السماوية
لإقامة الحضارة البشرية على أساس التوحيد والعدل وإرساء القيم الإنسانية السامية.
غير أن تاريخ البشرية، رغم ذاك، لم يكن ليسير سيراً مطرداً باتجاه تحقيق العدالة
الإنسانية والارتقاء نحو المطلق المتعالي. ففي عالم الاعتقاد كان الكفر، وكان الشرك
كما كان التوحيد. بنى الإنسان لنفسه عالماً من الأفكار والفلسفات المتناقضة التي
تعكس نظرته لوجوده ولغايته في الوجود ، وقامت حضارات واندثرت أخرى لنشهد أكبر حضارة
في تاريخنا البشري هي الحضارة المادية بوسائلها وقيمها التي تطرح نفسها بوصفها
حضارة عالمية شاملة.
لقد كانت تلك الحضارات بمثابة معركة العقل إزاء التحدي الذي تطرحه العلاقة مع
الطبيعة ومحاولة الإنسان لتلبية حاجاته المادية. لقد حاول تلبيتها من خلال الوسائل
التي راح يكتشفها بإعمال العقل ومن خلال معرفته بقوانين الطبيعة التي انتهى في
صراعه معها إلى تطويعها والسيطرة عليها. فمن عصر الصيد بوسائله البدائية إلى عصر
اكتشاف الزراعة وتدجين المواشي مروراً بخوضه أعماق البحار وسبر أغوار المحيطات
وصولاً إلى عنان السماء.
وفي مجال ترتيب العلاقات الاجتماعية كانت النظم الاجتماعية والسياسية التي استندت
إلى منظومات من القيم حيث اختلفت وتنوعت عبر مراحل طويلة من التطور البشري والتي
تشهد من خلالها محاولة إرساء العدالة ومنع الظلم والتجاوز فكانت رؤى الفلاسفة
والمفكرين الذين كانت لهم إسهامات كبيرة في رفد الحضارات البشرية بأفكار تعينها على
إرساء نظمها، كتلك التي كانت في بلاد ما بين النهرين مع الحضارة السومرية والبابلية
في الألفية الثانية قبل الميلاد، ومن ثم الحضارات الأخرى الفارسية والهندية
والفرعونية، فاليونانية والرومانية والإسلامية، وصولاً إلى العصر الحديث. رغم ذاك
حفل تاريخ البشرية بالكثير من الحروب والمجازر والتنكيل، ولم تستقرّ المسيرة
الطويلة لحياة البشر على منوال واحد، بل تراوحت بين العزلة، والاحتكاك، بين العنف
والتلاقح الثقافي، والاندماج الجغرافـي والديمغرافي. وارتبطت هذه العلاقات برؤى
ومواقف متباينة من الاحتلال والاستعمار، بين الرفض والتأييد والذي يجد تعبيراته
ومتعيناته بشكل خاص عبر الاحتكاك بين الحضارة الإسلامية وحضارة الغرب، التي ما زالت
تطرح السؤال على المسلمين حول أفق هذه العلاقة وحدودها، كما تطرح السؤال أيضاً على
شعوب العالم الثالث في ميدان سيرها في ركاب التطور، وفي موضوع صلتها بالحضارة على
المستوى الوطني والقومي والإنساني، وصلتها بتاريخها وتراثها وطبيعة قيمها وأساليبها
ومناهجها ورؤاها في مجالات العقيدة والتشريع والثقافة وكل أساليب العيش.
وبطبيعة الحال لم تطرح هذه المواقف والتساؤلات خصوصاً في عصرنا الراهن لولا وجود
حضارات بإزاء بعضها بعضاً مع وجود تبيانات في درجة الارتقاء الحضاري الذي يستند إلى
معايير تختلف باختلاف المنطلقات والرؤى حول هذه المعايير. ومع ذلك فإن انفتاح
العالم الناتج عن مسيرة التطور البشري، تبقي هذه التساؤلات ماثلة خصوصاً في مجال
حدود العلاقة ومجالات الانفتاح، والإسهامات الحضارية الخاصة وغاياتها المنشودة.
ففي العالم الإسلامي ومنذ لحظة الاصطدام بالاستعمار الغربي في القرن التاسع عشر
تراوحت المواقف بين اتجاهات ثلاثة، اتجاه منفتح بشكل مطلق على الغرب يدعو إلى تعميم
ثقافة الغرب واستلهام تجربته كما هي، واتجاه آخر يتراوح بين التراث والحداثة أي بين
ما هو موجود وأصيل وتوليفه مع الوافد، واتجاه ثالث يدعو للانفتاح على التراث
ومحاولة التطوير من الداخل دون الحاجة إلى الغرب.
وأما الخيط الذي يوصل بين هذه المواقف فهو الإحساس بالعجز الحضاري مقابل الغرب بغض
النظر عن كيفية اللحاق بركب التطور.
ومع الإحساس بهذا العجز، يطرح التساؤل في مكان آخر. لماذا كان هذا الإخفاق الحضاري؟
وقد كانت الإجابات كثيرة ومتنوعة، غير أننا وفي مجال التركيز حول أهمية العلم في
مسيرة التطور البشري، لا بد لنا من محاولة تبيين نظرة الإسلام للعلم والعقل وكيفية
التعامل مع المعرفة انطلاقاً من النصوص وصولاً إلى التجربة التاريخية مقارنة مع
الحاضر للوقوف فيما بعد على رؤية الإمام الخميني في مجال التحديات التي تواجه
الثورة الإسلامية باعتبارها ثورة تطرح نفسها في إطار التحديات الرؤيوية للحضارة
الإنسانية، من خلال المزج العضوي بين الدين والعلم لعلاج مشكلة الإنسان في عصرنا
الراهن، ولمعالجة تحديات التطور.
1 - أهمية العلم في الإسلام
تبييناً لأهمية التعليم في الإسلام يكفي الإشارة إلى أن أول آية نزلت على النبي
محمد‘ هي:
﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾1
, ومن ثم ما ورد من آيات كثيرة تحث على إعمال العقل وطلب المعرفة والعلم لأنه
بالعلم وحده يُعرف الله ويوحَّد ليصل الإنسان إلى تحقيق دوره في الاستخلاف. وقد
اقترن هذا الإلحاح بكون العلم يشكل المدخل الأول للتعرف إلى الباري سبحانه وتعالى
إلى حد إرجاع الخشية من الله إلى العلماء.﴿إِنَّمَا
يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء﴾2.
وفرق بين من يعلمون وبين من لا يعلمون
﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾3.
ولأهمية ما ورد في القرآن الكريم حول أهمية العلم حث الرسول الأكرم‘ المسلمين على
الاهتمام بهذا الأمر وجعله واجباً وفريضة "طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة"
"اطلب العلم من المهد إلى اللحد...".
بهذه الدعوة في نصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية المأثورة والتي باتت معروفة
لدى عموم المسلمين، نتبين الدعوة إلى الثورة الثقافية التي أولاها الإسلام حيزاً
كبيراً من الاهتمام وجعل الانشداد إليها محل تقدير إلى الحد الذي جعلها قرينة
للعبادة بحد ذاتها.
وبطبيعة الحال، ولأن الإسلام خاتم الديانات، وأنه نزل للناس كافة ولم يقرن بعصر
نزوله فحسب وإنما جعل ليكون هداية وشرعة للبشرية على امتداد الأزمنة، نجد أن تلك
الدعوة تشكل ضرورة لإحداث التغيير النوعي في المجتمع الجاهلي الذي كان يحفل
بالأساطير وبالجهل والانشداد إلى تقليد الآباء والأجداد وقصور النظام الاجتماعي عن
التطور ورزوحه تحت وطأة العادات القبلية والعصبية والجاهلية. كان ذلك مدخلاً
ضرورياً لإحداث هذا التغيير، غير أن عالمية الإنسان وإفصاح القرآن الكريم عن فلسفة
الخلق وغاية الإنسان في الوجود ما يؤكدان على أن دعوة القرآن الكريم إلى المعرفة
غير مقرونة بالزمان أو المكان وهي دعوة يراد لها بناء النموذج الحضاري الإسلامي
ليكون عاماً بين الناس، وليكون أساساً في مسيرة البشرية في ارتقائها نحو الله
﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا
فَمُلَاقِيه﴾4
ليُسأل الإنسان حينذاك عما قدمه لنفسه وما قدمته الأمة في معتركها الإنساني.
وبوصف الإنسان بالمعنى العام خليفة لله في أرضه، تزود بقدرة العقل وأُمر بإعمار
الأرض على أساس التقوى وإقامة العدل وأُنزلت له الرسالات السماوية مع الأنبياء
لإعانته على أداء هذا الدور المنشود، في الإعمار والإبداع والوصول إلى أقصى ملكاته
كممكنات مفتوحة على الارتقاء والصعود في مسيرة التكامل البشري.
إذن المرتكز الأساس للدعوة الإسلامية العامة، أنها تقوم على الإيمان بالعقل
والاستناد إليه في تثبيت عقيدة الإيمان بالله والانطلاق نحو بناء الحضارة
الإنسانية. فأول ما نزل به القرآن الكريم كان الدعوة إلى القراءة والعلم، والدعوة
إلى معرفة الله من خلال النظر بحقائق الوجود وتبيان ما فيه من إبداع ومن سنن
وقوانين. وبطبيعة الحال، هي دعوة عامة مفتوحة على التعرف الدائم إلى حقيقة الكون،
وهي أكبر وأعمق من أن يحدها جيل من البشر في مرحلة تاريخية واحدة لما فيها من أسرار
تعيَّن على الإنسان إدراكها من خلال منهج الملاحظة وإعمال العقل بالنظر أولاً إلى
حقيقة خلق الإنسان بحد ذاته
﴿فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، خُلِقَ مِن مَّاء دَافِقٍ﴾5
وما يحيط به من وجود
﴿أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاء فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا
وَزَيَّنَّاهَا﴾6
﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ...﴾7
والدعوة إلى النظر بأحوال الأمم والاستفادة من التجارب والوقوف على فلسفة تاريخ
قيام هذه الأمم واندثارها
﴿قُلْ سِيرُواْ فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُكَذِّبِينَ﴾8
ومن ثم تحكيم العقل والركون إليه فضلاً عن كونه معياراً للمفاضلة بين الناس
﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ﴾9.
وعلى هذا الأساس انطلق العالم الإسلامي باحثاً عن أحوال النجوم والفلك والرياضيات
والهندسة والطبيعيات، والنظر بفلسفة الوجود وسلك مناهج التأمل والتفكير والملاحظة
عاملاً على التطوير المطّرد لهذه العلوم.
لقد إقتبس المسلمون بعضاً من هذه العلوم ثم أضافوا اكتشافاتهم ومناهجهم بحيث يغدو
مستحيلاً درس تاريخ العلم بمعزل عن مساهمات المسلمين النوعية والمتعددة، فقد ترجم
محمد بن إبراهيم الفرازي كتاب "برهمبكت" المشهور: "السد هانتا أو سند هند"
الذي أهداه الفلكي الهندي "كانكا" إلى الخليفة المنصور وهو الكتاب الذي يتضمن أهم
ما احتواه تراث الهنود في الفلك والرياضيات.
وترجم إسحق بن حنين كتاب "الأصول والأركان" لاقليدس وهو خلاصة الهندسة
اليونانية. كما ترجم إسحق نفسه كتاب "المجسطي" الذي يحوي أهم ما توصل إليه "بطليموس"
في الفلك والرياضيات.
وبذلك يكون المسلمون قد أخذوا عن الهنود الأعداد والنظام العشري وعن الإغريق حساب "فيتوغوراس"
وهندسة أقليدس وفلك بطليموس10. ومن ثم أعادوا كتابة الحضارة اليونانية
كلها باللغة العربية، فترجموا كتب أفلاطون وأرسطو وتلامذتهما في الفلسفة، كما
ترجموا كتب أبقراط الطبية وجميع ما كتبه جالينوس في الطب وكتب أخرى ذكرها ابن
النديم وخاصة في صناعة العقاقير وطرق الاستشفاء، ونقلوا عن حضارة الفرس الأدب
والشعر والتاريخ والسياسة والإدارة وعلم النجوم.
في حين دخلت الحضارة الهندية بعلومها وأخلاقها وكانت حضارة الفرس دخلت الإسلام عن
طريقين الترجمة والإيمان بعدما أعطوا لحضارتهم انتماءً جديداً. أما علماء الهنود
أنفسهم فمنهم من بقي هندوسياً ومنهم من اختار الإسلام دينا11
إن اقتباس المسلمين عن غيرهم قد يطرح إشكالية حول أصالة الحضارة الإسلامية كما دأب
بعض المستشرقين علي القول معتبرين الحضارة الإسلامية قد تأسست على معطى خارجي.
غير أن الإسلام عندما أخذ عن هذه الحضارات عمل على استيعابها بروحية الإسلام
التوحيدية فضلاً عن تكييفها مع الشريعة. صحيح أن المسلمين استفادوا من تجارب
الآخرين ولكنهم أعطوا للآخرين ما أبدعوه في مجالات كثيرة وقد برز ذلك في شواهد
كثيرة فعلى سبيل المثال:
أبو بكر الرازي كان كتاباه رسالة في الجدري والحاوي... مرجعاً لدراسة الطب في الغرب
لعدة قرون.وقد برع في خياطة الجروح، إذ كان أول من استعمل أمعاء الحيوان في
التقطيب، وكان أول من عالج أمراض الجدري والحصبة.
من جهته ظل كتاب "القانون" لابن سينا متربعاً على عرش المعرفة الطبية في
العالم حتى القرن السابع عشر، إذ احتوى على 760 عقاراً للمعالجة. وكان ابن الهيثم
قد أثبت بطلان نظرية "بطليموس" حول الانعكاس الضوئي عندما اعتبر الرؤية
نتيجة لانعكاس الضوء الخارجي في العين بدل العكس، بالرغم من أن الغرب ينسب نظريات
ابن الهيثم في القرن العاشر الميلادي حول انعكاس وانكسار الضوء إلى نيوتن في القرن
السابع عشر كما نسب إلى "وليم هارفي" اكتشاف الدورة الدموية الصغرى التي
توصل إليها "ابن النفيس" الذي كان أول من تحدث عن تنقية الدم في الرئتين
وانتقد نظرية "جالينوس" المتعلقة بمجرى الدم الوريدي من البطين الأيمن
والبطين الأيسر12.
لم يقتصر الأمر على المعارف الطبية وإنما تعداه إلى حقول معرفية متنوعة فقانون
الجاذبية عرف تطوراً ملحوظاً على يد "الخازن" الذي كان أول من تحدث عن جذب
الأجسام إلى الأرض وحدد قوانين الجاذبية انطلاقاً من سرعة تساقط الأجسام وأوزانها
قبل نيوتن بعدّة قرون.
وهو الذي اكتشف الضغط الجوي قبل "تورشيلي". وكان البيروني وابن سينا قد
اكتشفا أن الضوء أكبر من سرعة الصوت ومثله في الرياضيات والهندسة حيث ظل جبر
الخوازمي طاغياً على كل ما سبقه، إضافة إلى اكتشاف العدد "الصفر" والكسور
العشرية، والمتواليات الحسابية والهندسية، وحسابات التكامل والتفاضل، واللوغاريتم،
والمضلعات وتصنيف المساحات والأحجام13. كذلك كان المسلمون قد صنعوا
الروافع والطواحين، ومضخات المياه، والموازين وأنابيب السوائل والساعات المائية
والشمسية ورقاص الساعة، والدمى والفوانيس الزيتية، وأبدعوا في صناعة المراصد
والآلات الفلكية والأسطرلاب إضافة إلى معرفة متنامية بمواقع الكواكب والنجوم14
، والكثير من الإبداعات التي لا يعتري الشك الباحثين في نسبتها إليهم، رغم المنطق
الإنكاري لدعاة تمايز الحضارة الأوروبية.
2 - الارتباط بين العلم والإيمان
لتفسير معالم الارتباط بين العلم والإيمان ومن ثم الوقوف على رأي الإمام الخميني
يقتضي الأمر أولاً عقد مزاوجة بين العمل والعلم باعتبار أن العلم هو مختصات العقل.
علماً أن كلمة عقل لم ترد في القرآن، بل وردت كلمة القلب كدلالة على تلك العلاقة
التي أسسها الإسلام بين العقل والإيمان.
القلب كما ورد في القرآن الكريم هو عقل يتدبر به المسلم أمور دينه ودنياه."من كان
له قلب" هو بحسب المفسرين من كان له عقل و"أولي الألباب" يعني أولي العقول.
والأفئدة جمع فؤاد وهو القلب.وحسب تفسير العلامة الطباطبائي المراد به في القرآن هو
الشعور والفكر. والقلوب الواردة في القرآن مرادفة للعقول وإليها تعود مهمة التعقل
والتفقه بحسب الآية 179 من سورة الأعراف
﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا﴾15.
والقرآن الكريم كان قد حدد غايات العقل بتوجيهه نحو معرفة علمية بالكون والطبيعة
والإنسان من خلال التبصر والنظر.وإنما حث أيضاً البشر على تشغيل العقل في معرض
تنظيم شؤون دنياهم على قاعدة الالتزام بما جاء به الوحي من هداية والتمييز بين
الخبيث والطيب من خلال ما جاء به النبي من تشريعات.
العقل بحسب القرآن الكريم يمثل جزءاً لا يتجزأ من الكائن البشري وبالتالي يمثل
المساواة الإلهية في تكوين المخلوق. فهو واحد لدي الأفراد ولكن يختلف عقل فرد عن
آخر في خاصية التفكير في حكمة الخلق من ناحية، وفي كيفية السلوك الدنيوي المجتمعي
من ناحية ثانية. فإذا حقق العقل قدرته عمل الاستدلال والربط بين الظواهر الطبيعية
من خلال ما تراه الحواس ظاهراً وبسيطاً ومرتبطاً بها يصل إلى معرفة الخالق فيتدعم
الإيمان بالتدبير الإلهي، وكذلك إذا تعقل الإنسان الأوامر والنواهي، يضع في سياق
واحد العقل والإيمان، وهو يضع تجربته في الحياة، بحيث يصبح قادراً على تنظيم
الاجتماع البشري تنظيماً عقلياً يأخذ من الإيمان تفريقه بين الحق والباطل، والخير
والشر، ويقيم معرفة مؤمنة ترشد العمل وتحدد غاياته، وينتهي العقل هكذا إلى تأسيس
مسؤولية مزودجة، مسؤولية الإنسان تجاه الله، ومسؤوليته تجاه نفسه والمجتمع والطبيعة16.
أما حول نظرة الإنسان نفسه للعقل كعقل مستقل عن الإيمان الديني، فنجده في مسار
تاريخي طويل يمتد إلى عهد اليونان حين كان هناك علماء يعتبرون أن الإنسان مقياس كل
شيء، وكانوا يرون هذا في مجال الفلسفة والعلم وأن معيار الواقعية والحقيقة هو
الإنسان وما يراه. فإن رأى هذا الشيء حق، فهو حقاً وإن رآه باطلاً فهو باطل.
الإنسان معيار الحقيقة وليس العكس فلو كنا نقول إن الله موجود فبما أن الإنسان يراه
كذلك فهو حقيقة، وإن قيل غير موجود، فإن الله معدوم وهكذا17.
في القرون الوسطى - مع سيطرة الكنيسة طوال هذه العصور - خضع العقل لسلطة تفسير النص
الديني. ومع عصر الحداثة كان الغرب قد أعطى في صراعه مع الكنيسة للعقل سلطة عليا
بمعزل عن أي ارتباط بالنص الديني التأويلي. ولكن سيتكرر مع الغرب هذا الإنسان
كمقياس للحقيقة، وسيتوحد الإنسان مع الطبيعة وفق مبدأ الواحدية المادية في عالم
مادي لا يشير إلى شيء خارجه هو عالم تم إلغاء الثنائيات داخله، ثنائية الإنسان
والطبيعة، وثنائية الخالق والمخلوق. وفي مثل هذا العالم المادي لا يوجد شيء للوهم
القائل إن الإنسان والطبيعة يحويان من الأسرار ما لا يمكن الوصول إليه، وإن فيه
جوانب غير خاضعة للقوانين المادية. كما يمكن إخضاع كل شيء للمقاربة التجريبية ويصبح
العالم الطبيعي المصدر الوحيد للمنظومات المعرفية والأخلاقية ويظهر العلم المنفصل
عن الأخلاق وعن الغائيات الإنسانية والدينية. وقد أحرز هذا النموذج المادي التفسير
شيوعاً غير مسبوق وشاعت معه قدرة العلم على تفسير كل ما يحيط بالإنسان وقدرته على
حل مشاكله بمعزل عن أي مطلقات18.
حتى القرن السابع عشر أي قبل بروز ما يسمى عصر الأنوار، كان الإنسان الغربي يفكر
انطلاقاً من الله. لقد كان أولاً هناك الخالق، الكائن المطلق اللامتناهي. وبالعلاقة
معه، كان الكائن البشري يعرف نفسه كنقص متناه مقابل الكامل اللامتناهي. وكان الله
يأتي منطقياً، أخلاقياً وميتافيزيقياً قبل الإنسان. كان لا يزال يتوافق مع التأسيس
الديني للأخلاق. في عصر الأنوار شهدنا العودة إلى تأكيد الكائن البشري في كل ميادين
الثقافة، إلى حد أن الله بدأ يظهر كفكرة عند الإنسان. برزت فكرة احترام الإنسان
للآخر من المنظور القيمي المادي، إذ لا حاجة للدين لكي نكون نزهاء مستقيمين، ولا
حاجة بنا إطلاقاً للإيمان بوجود إله للقيام بالواجب الأخلاقي، ولم يعد الإيمان
بوجود الله يحكم الفضاء السياسي في عالم علماني اختفى فيه الله كلياً وأصبح شأناً
شخصياً ينتمي إلى الحياة الخاصة، فيما فرض على المجال العمومي أن يتخذ بهذا الصدد
موقفاً خاصا.19
وبهذا المعنى شكلت المادة عصب النهضة، وأرخت بكل أثقالها على نهضة المعرفة وتربعت
العقلانية على قمة النظام الفكري حيث لم يعد العقل مقموعاً من الكنيسة، ولم يعد
الاهتمام موجوداً حول جدوى الإيمان بألوهية تنتظم وفق مبادئها حركة البشر والعالم،
فقد افترض العلم أن الواقع هو ما يثبته العلم وحده وانتهى الأمر إلى انكسار العلاقة
بين العقل والإيمان لصالح الأول، بحيث بات العقل تعبيراً عن سيادة المادة التي
أنتجت مفهوماً للدولة بدون حاجة إلى مرجعية دينية، وأسس لتوازن مجتمعي وفق مبادئ
السوق والثروة والملكية والمصلحة الشخصية والتقدم المجتمعي، دون انتظار تعويض ما في
مملكة السماء20.
وهكذا لعبت أصولية المادة دوراً حاسماً في سيادة المطلق الرأسمالي وحلت مطلقات
العقل التي باتت توظف في كل شيء.في القدرة على معرفة قوانين الوجود، في التقدم، وفي
وسائل قيام نظم اجتماعية تعكس الرفاهية والسلام بدون ضوابط إنسانية أو محرمات
دينية.
لكن السحر سرعان ما انقلب على الساحر وسرعان ما وقع العلم في المصيدة التي أعدّها
بنفسه، فلقد تحول العلم إلى نقيضه أي صار غير علمي حين دخل في دوامة النسبية.
فبالنظر إلى التحولات التي طرأت في ميدان الفيزياء، وأهمها ظهور نظرية النسبية
وبطلان مبدأ الحتمية، أصبح من الممكن إعادة النظر في صدق النظريات العلمية ومناهج
العلوم الطبيعية. كما أنه أصبح من المشكوك فيه إمكانية تفسير الوجود بالانطلاق من
العلم وحده. ولقد لعب الفلاسفة الفرنسيون والألمان على وجه الخصوص دوراً هاماً في
عملية نقد العلم هذا، ودحض النظريات العلمية وتجريدها مما نسب إليها من قيم مطلقة
وروجوا لمذهب في النسبية داخل العلم، ومن بين هؤلاء كان كارل بوبر، وتوماس كون
وباول فاير. وبنظر هذا الأخير كان العلماء وفلاسفة العلم قبل ذاك، يدافعون عن العلم
برغبة جامحة لفرض سيطرتهم على العقول. كان العلم بنظر هؤلاء وحده هو الصحيح، وقد
استطاع أن يحقق نتائج باهرة أو يتفوق على غيره، لأنه كان بمنأى عن النقد نتيجة
ارتباطه بمراكز القرار التي تستعمله لأغراضها الخاصة.
لا يشذ موقف الإمام الخميني قدس سره عما انتهى إليه الذين نظروا إلى العلم بعين
الشك والريبة، بل إنه مضى حتى أقصى الممكنات التي تصل العلم بالإنسان في فهم
الطبيعة لينتهي به إلى عالم مجهول هو عالم ما وراء الطبيعة حيث لا تستطيع العقول
مهما بلغت من قدرة على التفسير الإحاطة بهذا العالم. إن هذا القصور هو عند الإمام
الخميني قدس سره بمثابة أحد معالم الارتباط بين الإيمان بالعلم من جهة، وعدم تجرد
العقل عن الإيمان الديني. فلو جمعت كل طاقات البشرِ ووضعت فوق بعضها بعضاً لتمكنت
من فهم خاصية الطبيعة فقط، علماً أن خصائص الطبيعة لم يكتشفها البشر بأجمعها ولكن
الإمام الخميني قدس سره كان أكثر تفاؤلاً في هذا المجال من علماء النسبية أنفسهم
حيث يرى أن ما يجهله العلماء حول الطبيعة يمكن أن يكتشف فيما بعد، ولكن مهما يكن من
أمر، فإنه لن يخرج عن إطار الطبيعة، لأن الشيء الوحيد الذي يمكن للإنسان أن يدركه
يدخل ضمن حدود إدراكه الطبيعي. فلو تمكن من فهم كل خصوصيات عالم الطبيعة وكل ما
يرتبط بكمالها، ولو حاول الإنسان حتى النهاية وبذل جهده، فإنه يتمكن من معرفة تلك
العلاقات التي بين الأشياء في الطبيعة، والعلة والمعلول، والسبب والمسبب، فلو اكتشف
الزلزلة وعلاقتها بالأرض، ومتى تحدث وما هو نوعها وقوتها واكتشف كل ما تبقى من
علاقات ولم يبق مجهول أمامه، فإنه سيبقى ضمن إطار الطبيعة ولا يمكنه أن يتحرك خارج
حدودها وفوقها ويدرك ما وراءها. ومن هذا الاستدلال يربط الإمام الخميني قدس سره بين
الإيمان بقدرات العلم المحدودة، والإيمان الديني أو الإيمان بالوحي, لأن عالم ما
وراء الطبيعة بحاجة إلى معانٍ أخرى في العمل، تقوم على أساس الاعتقاد بما جاء به
الأنبياء الذين بعثوا لتربية الجانب الآخر من الإنسان21.
تتضح منهجية الإمام الخميني قدس سره في الربط بين العلم والإيمان من خلال مسيرة
العلم نفسه سواء في المراحل التي أعلن فيها الإنسان الغربي عن تقديسه للعقل
وللإنسان نفسه من خلال هذا العقل، والذي انتهى إلى المزيد من التوجه نحو مركزية
الإنسان في الكون. فبمجرد أن بدأ العلم يفقد جدارته، اتجهت الأنظار إلى التوابع
السلبية الممكنة للعلم على الوجود الإنساني، وبدأنا نسمع منذ نهايات ثمانينات القرن
العشرين، خطاباً أخلاقياً يعلن نفسه في العلم ويتعلق بحفظ البشر من الأضرار
المحتملة الصادرة عن العلم نفسه، فظهرت اللجان الأخلاقية، المكلفة بتقييم نتائج
وعواقب التقدم العلمي. أما في الفلسفة التي كانت قد بشرت بمجيء الإنسان الأعلى،
والتي شرطت التخلص من فكرة الإله التي تقف عقبة في سبيل حرية الإنسان وقوته
الإبداعية فسرعان ما فشلت في محاولاتها، إذ عرف الفكر الفلسفي المعاصر ابتداءً من
الستينات تيارات فلسفية جديدة راحت تردد بأصوات عالية " إن الإنسان كما تصورناه،
وكما أحببناه فينا وفي غيرنا، ودافعنا عنه وعن قضاياه، لم يعد له وجود أو هو على
وشك الاختفاء والموت، لأنه لم يعد بالإمكان الدفاع عن تصورات مثالية للإنسان أو
التبشير بها، إذ يكفي استحضار ما وقع بين الحربين العالميتين الماضيتين، أو في
راوندا، أو في البوسنة، أو في العراق ليبرز لنا أنه بدل أن يحل الإنساني محل الإلهي
حل محله الشيطاني، وأننا ما زلنا على حد تعبير لوك فيري بعيدين عن القضاء على
الشيطان لأن الفلاسفة بدل أن يشغلوا بالقضاء على الشيطان انشغلوا بالقضاء على الله
بعدما كان لآلاف السنين يلهم كل مجالات الثقافة البشرية من الفلسفة إلى الفن إلى
الأخلاق22.
لم يكن ذلك ليحدث في مسارات العلم والفلسفة لولا الارتكاز على الفصل بين قدرة العقل
الإنساني على حل كل الألغاز المحيطة بعالم الإنسان وقدرة العقل على الارتقاء
وحيداً، ولكنه ما زال يحصد الإخفاق تلو الإخفاق طالما لم يحضر البعد الإيماني ولم
يكن رديفاً للعقل.
كان الإمام الخميني قدس سره على غرار سائر الفلاسفة والعلماء يؤمن بقدرة العلم
وبقدرة العقل، ولكنه لم يكن على الإطلاق ليجعل منه عقلاً مجرداً بل مسنوداً إلى
الفطرة التي فطر الله الناس عليها. هذه الفطرة هي التي تقود الإنسان نحو الله فاطر
السماوات والأرض، فطرة المعرفة التي تقود الإنسان نحو الكمال المطلق وأصل حقيقة
الوجود وإلى العلة التامة.
يستند الإمام الخميني قدس سره إلى ما ورد من آيات في القرآن الكريم ليربط بين العلم
وضرورة الإيمان ليس فقط من أجل ربط عالم الشهادة بعالم الغيب، وإنما من أجل تفسير
أسباب ارتكابات الإنسان للظلم جراء عدم تربية النفس وعدم الإقرار بتعاليم الأنبياء،
فالآية الأولى في القرآن الكريم هي
﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾23
فدُعي َ الرسول الأكرم منذ البداية للقراءة، و جاء في نفس هذه السورة
﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى، أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى﴾24.
يرى الإمام الخميني قدس سره أن تحول الإنسان إلى طاغوت هو من أخطر الأمور، وللتخلص
من هذه الحالة، لا بد من تعليم الكتاب والحكمة، لأن الإنسان بنظر الإمام يطغى بمجرد
أن يستغني. الاستغناء المالي يجره إلى الطغيان بقدر هذا الاستغناء، ويطغى الإنسان
عندما يستغني علمياً، وعندما يحصل على مقام بمقدار ذلك المقام، بل إن سائر الأمور
الدنيوية تجره إلى الطغيان فيما لو لم يزك ِّ نفسه.
وإن جذور جميع الاختلافات بين البشر وبين السلاطين وبين أصحاب النفوذ تعود إلى
الطغيان الموجود في النفوس، وغاية البعثة تزكية الناس حتى يتعلموا ولو تزكوا لما
حصلت كل الاختلافات بين البشر.
وعلى هذا الأساس فإن حصر الإنسان بالبعد المادي وحده، والإيمان بحريته وإمكاناته
على حل مشاكله الخاصة ومشاكل وجوده الاجتماعي، يبقى قاصراً عن بلوغ المراد. يشير
الإمام الخميني قدس سره إلى نتائج تفرّد الإنسان بالعقل العلمي وحده بالقول "هؤلاء
الذين يدّعون أنهم عرفوا العالم، فقد عرفوا جانباً متدنياً من العالم، واكتفوا بذلك،
وأولئك الذين يقولون بأنهم عرفوا الإنسان، فإنهم عرفوا شبحاً من هذا الإنسان، وليس
الإنسان نفسه، لقد عرفوا شبحاً من حيوانية الإنسان، وظنوا أن هذا هو الإنسان".
وبهذا المعنى، نجد أن الإمام الخميني قدس سره يشدد من خلال ربط العقل بالإيمان على
تفوق العلم الإلهي ويجعله فوق المعرفة البشرية، وتابعاً للوحي ، في معرض بحثه عن
الحقيقة، ويجعله مكملاً للإيمان في حقل التشريع. ومعه يظل هذا العقل خلقاً إلهياً
مهمته التفكر في تجليات الألوهية في هذا الوجود بدون أن ينتهي إلى تعظيم الإنسان
ومعارفه على حساب العلم الإلهي المطلق، وهي الرؤية التي تظهر بصورة معكوسة في الغرب
منذ صراعه مع الكنيسة وانتهاءً بعصرنا الحالي...
إن الربط بين العلم والإيمان وفق الإمام الخميني قدس سره، تبرز فيه توحيدية الإسلام
على أساس نظامه الفكري الذي ينعكس في صميم الفعل الإنساني ورؤيته لعلاقته مع الله
ومع ذاته ومع العالمية الإنسانية كرؤية للأخوة في الدنيا والآخرة، على النقيض من
الرؤية المادية التي تجعل الإنسان سلعة خاضعة لمقاييس الاستخدام المادي، والاستغلال
في دنيا منفصلة عن الآخرة. يقدم الإمام الإسلام بوصفه رؤية عامة للوجود وبوصفه قيمة
مرجعية للعلاقات بين البشر وبين الإنسان والطبيعة، والإنسان مع المطلق المتعالي
اللامتناهي وحضوره في التجربة البشرية من خلال الأنبياء والرسل لكي يوصلها في نهاية
الأمر إلى الكمال عبر اتباعها الصراط المستقيم الذي يخرجها من الظلمات والشكوك
والتمزق.
3 - ماهية العلم في فكر الإمام الخميني
قبل أن يشهد العلم هذه التخصصية الموجودة في عصرنا الحالي كانت الفلسفة هي أم
العلوم، وكان موضوعها هو الوجود، وما وراء الوجود، والإنسان.25 مع
التطور انقسمت هذه العلوم إلى قسمين علوم طبيعية وأخرى إنسانية، ضمت العلوم
الطبيعية. الفلك، والفيزياء، والرياضيات والكيمياء، والطب وغيرها، وصارت العلوم
الإنسانية تضم الفلسفة، والسياسة، والتاريخ، وعلم الاجتماع والنفس وغيرها من العلوم
، وأصبح لكل فرع من فروع هذه العلوم فروع متخصصة. وقد حققت هذه العلوم جراء تطورها
وتخصصها، الكثير من الإنجازات والكشوفات. ومعها ساد الشعور أن العلوم قادرة على حل
كل مشاكل الإنسان، في رؤيته لنفسه، ورؤيته للعالم المحيط به، ولتفاعلاته مع سائر
البشر.
لم يقف الإسلام متفرجاً إزاء هذه العلوم بل كانت له إسهامات كبيرة وجادة في تطورها.
غير أن إشكالية هذه العلوم لم تقف عند حدود إنجازاتها، وإنما عند النتائج التي
توصلت إليها، ومن بينها التشكيك بما جاءت به الأديان وعالم النبوات، والفصل بين
عالم الطبيعة وما وراء الطبيعة، وفصلها عن منطق التوحيد الإلهي في عالم الوجود.
الإسلام بنظر الإمام الخميني قدس سره إذ يفتح العقل على باب النظر والتقصي في حقيقة
هذا الوجود، جاء ليعيد جميع المحسوسات وجميع العالم إلى مرتبة التوحيد، فتعليماته
ليست تعليمات طبيعية أو تعليمات رياضية أو طبية أو التي تدرس في ميادين شتى، إنها
تشمل كل تلك، ولكنها مرتبطة بالتوحيد الذي ينتهي إلى مقام الألوهية.
فالمعنى ـ وفق الإمام الخميني قدس سره ـ الذي تبتغيه العلوم الجامعية هو ذو قيمة
كبيرة، ولكن ثمة فصل بين المعنى الظاهري وهو معنى مشترك بين كل العاملين في حقل هذه
العلوم، والمعنى الذي يبتغيه الإسلام، وهو أن ترتبط جميع هذه العلوم الطبيعية أو
غير الطبيعية بالتوحيد أي أن يكون لكل علم جانب إلهي، فيرى الإنسانُ الله عندما
ينظر إلى الطبيعة، ويرى الله عندما ينظر إلى المادة، وسائر الكائنات. مع أنه لا بد
من وجود الطب، ووجود العلوم الطبيعية، والعلاج البدني إلا أن المهم هو مركز الثقل
هو التوحيد الذي ينظر إلى تلك المعنويات بتلك المرتبة العالية، أي حين يستحضر صورة
الألوهة من خلال الطبيعة، وأنها موجهة من عالم الغيب، ولو نظر الإنسان إلى الطبيعة
بهذا العنوان كان يمكنه أن يكون كائناً إلهياً.26
أن يكون الإنسان كائناً إلهياً يعني تحسس كل ما في الوجود من عظمة ليجد فيه تجليات
النور الإلهي، والتفكر في طبيعة التجربة البشرية لاستخلاص ما في أحوال الأولين من
عبر. وهو ما نجده في مقاصد القرآن الكريم حيث كثرت فيه الدعوة إلى التفكر وتمجيده
﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ
إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾27
وكذلك في موارد أخرى
﴿فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُون﴾28.
ومن خلال الربط بين العقل والإيمان يرى الإمام الخميني أن هناك الكثير من الآيات
التي فيها مدح عظيم للتفكر. وينقل الحديث عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في
معرض إيضاحه للآية 190 من سورة آل عمران
﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الألْبَابِ﴾
حيث يقول الرسول الأكرم "ويل لمن قرأها ولم يتفكر بها". والعمدة التي يراها الإمام
في هذا الباب أن التفكّر هو تلمّس البصيرة للوصول إلى المقصود وهو السعادة المطلقة
التي تحصل بالكمال العلمي والعملي إلى السلامة المطلقة وعالم النور والطريق
المستقيم29.
4 - تحرير الأفكار من التبعات (العقل والحرية)
إن معالم الارتباط التي تجسدت بين الإيمان والعقل الذي استلهمه الإمام الخميني من
رؤية الإسلام لتلك العلاقة وهي تعبير عن نظرة محددة للإنسان ببعديه الروحي والمادي،
وبالفطرة المستودعة لديه من الباري تعالى هي فطرة معرفة الله وتعقل الموجودات،
وسعيه نحو الارتقاء في مدرجات الكمال.
ولما كان العقل الخاصية المميزة للإنسان عن سائر الموجودات، غير أن هذا العقل في
ممارسته لوظيفته وفي احتكاكه مع عالم الطبيعة وتعقله للتجربة الذاتية ولتجربة
الآخرين، سرعان ما يلحق به الكثير من التبعات التي تحرفه عن الغايات المنشودة من
وراء ممارسته لوظيفته. ولذلك كان الإمام الخميني قدس سره قد عمد وفي مناسبات متنوعة
إلى الدعوة إلى تحرير هذا العقل من القيود وهي كثيرة وهي بمثابة أوهام لا بد من
إزالتها من عالم التأثير الذي يحجب الإنسان عن أن يكون إنساناً إلهياً وإنساناً
مستخلفاً لله في أرضه.
أ- وهم التقليد
من المعلوم أن الإنسان أكثر ما يؤثر ببنائه العقلي والوجداني هو الثقافة السائدة
التي يكتسبها بالتنشئة، فالثقافة في أي مجتمع كان هي التي تشكل هوية ذلك المجتمع،
وإن أي انحراف ثقافي يؤدي إلى خواء المجتمع وشعوره بالفراغ رغم أنه قد يكون مقتدراً
في المجال الاقتصادي والسياسي والصناعي والعسكري.
وقد كان للإمام الخميني قدس سره اهتمام خاص في تحقيق الاستقلال الثقافي الذي غاب عن
العالم الإسلامي بفعل تبعية المسلمين للثقافة الغربية. رفع الإمام شعار لا شرقية لا
غربية الذي يحمل دلالات متنوعة، بينها الدعوة إلى الاستقلال الثقافي والفكري
والدعوة إلى التحرر من وطأة تبعية المسلمين للغرب. وقد استوحى هذا الشعار من إحدى
آيات القرآن الكريم:
﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ
فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ
دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا
غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى
نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ
لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾30.
ومن خلال هذا الشعار كانت الدعوة للاستقلال الفكري لأن الارتباط بالثقافة المخالفة
يُفقد الثقافة الأصلية وجودها، ولذلك فإن من السذاجة وفق رأيه أن نتصور إمكانية
تحقيق الاستقلال في أبعاده المختلفة مع وجود التبعية الثقافية التي دأب الاستعمار
على إحلالها محل ثقافة المجتمعات.
ولفهم موقف الإمام الخميني قدس سره من مسألة التبعية في أسبابها ومظاهرها وأبعادها
يمكن الوقوف على نصوص من كلام له، حيث يرد أسباب هذه التبعية إلى ارتباطها بالبعد
النفسي والثقافي. وبالتالي هي مسألة تعود إلى فقدان الشعب ثقته بنفسه من جهة،
وانبهاره المطلق بالشعب المتبوع إلى درجة التقليد والأتباع الأعمى من جهة ثانية31.
أما مظاهرها فتبدو في مواضع متفرقة ففي خطاب ألقاه بتاريخ 5 أيلول عام 1979 قال: إن
جميع مشاكلنا ومصائبنا هي أننا فقدنا أنفسنا وجلس غيرنا في مكاننا. إن ثقافتنا
واقتصادنا كانا غربيين، ولقد نسينا أنفسنا حقاً.لقد نسي الشرقيون مفاخرهم كلها
ودفنوها ووضعوا الآخرين مكانها. وعندما يذكرون الموضوعات يستشهدون بأقوال الغربيين،
وهذا هو العيب، إنهم متأثرون بالغرب، إنهم نسوا ألفاظهم ولغتهم، وما دامت هذه
التبعية موجودة فلن يكون هناك استقلال32.
ويقول في هذا المجال: لا تشتبه عليكم الأمور عندما تشاهدون تقدم الغربيين في مجال
الصناعة، ولا تتصوروا أنهم متقدمون في مجال الثقافة أيضاً، ينبغي لكم أيها الطلبة
الجامعيون الأعزاء، أن تفكروا بكيفية التخلص من هذا التغرب والعثور على ما ضيعتموه
وأن نكون مستقلين وأحراراً.33
الاعتماد على الذات تلزمه خطوات متضافرة ليست محصورة بالجامعيين وحدهم وإنما بكافة
مكونات المجتمع من أجل بناء الإنسان. يقول الإمام في هذا الصدد: لا يمكننا إصلاح
الأمور ما لم نبنِ على أننا بشر، ويمكننا العمل لأنفسنا، وأننا مستعدون لتناول
الخبز المصنوع من الشعير هنا ولا نريد شيئاً من الخارج. لا يمكننا أن نحقق
الاستقلال ما لم يصمم هذا الشعب على أن يكون كل شيء من عنده، وأن تكون ثقافته من
عنده واقتصاده من عنده. إن الدعاية سلبت منا آدميتنا وأوجدت عندنا يقيناً بأنهم كل
شيء. بم تختلفون عن سائر البشر؟ البشر في كل مكان من جنس واحد ومن نوع واحد... إنهم
لم يسمحوا للأفضل عندنا أن يكون، ولهذه العقول المفكرة أن تعمل. إن العقول المفكرة
التي هربت من إيران إنما كانت أفكارها تعمل لخدمة الأجانب، ولكن الحمد لله فقد
أثبتم وأثبت شبابنا قدرتهم على العمل. ثقوا أنكم قادرون على القيام بجميع الأعمال
في المستقبل الطويل. وآمل أن تُعملوا العقول، وتنزعوا عنكم تلك المخاوف التي أوجدها
الغرب والشرق في بلادنا.مارسوا عملكم الثقافي بشجاعة أيضاً، ومارسوا أعمالكم
بأنفسكم، وقللوا اتكالكم على الأجانب34 .لقد نجوتم إلى حدٍ كبير من تلك
المصائد والشباك حيث هبّ الجيل المعاصر إلى العمل والإبداع.وقد رأينا ما أنجزه في
العديد من المصانع وفي أجهزة الطائرات وغيرها في وقت لم يكن يتصور أن الخبراء
الإيرانيين قادرون على تشغيل المصانع وأمثالها في ظل المقاطعة المفروضة والحرب
الاقتصادية. أوصيكم أن تقطعوا دابر التبعيات بإرادتكم الصلبة شريطة التوكل على الله
والاعتماد على النفس35.
ب ــ وهم الحرية
اقترنت الدعوة عند الإمام الخميني قدس سره إلى الاستقلال الثقافي كمقدمة للتخلص من
سائر أشكال التبعية بإبراز مظاهر هذه التبعية وخطورتها على هوية المجتمع الإسلامي.
ومن بين مظاهر هذه التبعية كان وهم الحرية وهو المفهوم الذي ساد في الأوساط
الأوروبية بعد الثورة الثقافية في القرن الثامن عشر في أوروبا عندما برز المفكرون
بأفكارهم المناهضة للكنيسة في معركة استقلال العقل عن المؤثرات الدينية وتزامن ذلك
مع نظرة جديدة للإنسان اقترنت مع ماعرف بالحقوق الطبيعية وعلى رأسها الحرية.
وفي أعقاب امتدادات الثورة في القرن التاسع عشر/ كان الغرب قد نظم مجتمعاته على
أساس الفهم الجديد للحرية التي سرعان ما شكلت موئلاً للمثقفين في عالمنا الإسلامي
الذي راح يستلمهم الغرب في مناهجه التعليمية مركزاً على إبداعات الغرب خصوصاً في
المجال الثقافي والفكري، وترافق الأمر مع بروز سلوكات جديدة نابعة من الدعوة إلى
التنميط الثقافي الذي يحاكي الغرب كتعبير عن حق الإنسان في حريته.
ولما كان هذا التنميط هو بمثابة أحد أهم عناصر الثقافة المكتسبة من خلال الأطر
التربوية والتعليمية، كان الإمام الخميني قدس سره شديد الحرص على تنقية المناهج
والجامعات من رواسب هذه التبعية، لا سيما أن هذه المراكز تضطلع بتخريج الكفاءات
العاملة في ميادين شتى في المجتمع و منها وسائل الإعلام، والفن، والإدارات التي
تضطلع بصناعة الرأي العام.
وبطبيعة الحال وقف الإمام الخميني قدس سره في مواجهة سائر أشكال التبعية.ولم يكن
يعمد لذلك إلا بعد توضيح ملابسات وتعقيدات نتائج هذه التبعية وبينها وهم الحرية
السائد كما في الغرب. دون أن يعني هذا الأمر أن للإمام الخميني نظرة سلبية لمفهوم
الحرية بقدر ما يعبر عن نظرة خاصة متوائمة مع تأصيله الإسلامي لكل ما يمت للإنسان
بصلة.
الحرية بنظر الإمام الخميني قدس سره هي نعمة إلهية ممنوحة للبشر، وهو يجدها قد
تحققت مع انتصار الجمهورية الإسلامية، وهذه الجمهورية ليست سوى ثمرة شعور الأفراد
بالتحرر من كم الأفواه الذي كان سائداً في زمن الشاه. ومع تحقق نجاح قيام الجمهورية
الإسلامية، تبقى هذه الحرية مصونة ارتكازاً على تعاليم الإسلام التي تمنح الإنسان
حرية العمل والاعتقاد.
ولكن للإمام الخميني قدس سره نظرة مغايرة لمفهوم الحرية كما هو سائد وفق الطراز
الغربي الذي يراه يؤدي إلى الانحراف وتدمير الشبان والشابات، وهذا الطراز الذي أذن
له أن يكون سائداً في جامعات ومدارس إيران كما في سائر زوايا المجتمع.
من بين أكثر ما يتم من خلاله التنظير لهذا الطراز وسائلُ الدعاية والخطابات والكتب
والصحافة. وبطبيعة الحال إن الفئة المولجة بهذا الأمر، هي فئة المثقفين والجامعيين
الذين يضطلعون بأدوار تناسب مؤهلاتهم. استناداً إلى هذا الأمر، كان الإمام الخميني
قدس سره شديد الحرص على دعوة هذه الفئات كما سائر أفراد المجتمع، إلى التنبه لخطورة
هذه المسألة. يقول في هذا السياق "إننا ومنذ اليوم الأول الذي تحققت فيه ثورتنا
كانت جميع الحريات موجودة، ولكن هل من الصحيح أن يتحدث الإنسان بما يشاء تجاه
الآخرين بحيث تدب الفوضى؟ هل هذا هو معنى الحرية؟ هل الحرية في الغرب التي تريد
نهبنا هي على هذه الشاكلة؟.. إنهم أرادوا الحرية التي تمكنهم من إفساد إخواننا
وشبابنا، إنهم يريدون حرية الفحشاء بكل أنواعها... في حين أن الحرية الأولية لأي
شعب من الشعوب هو حق تقرير المصير. فهل هذا كان سائداً خلال الحكم البائد الذي عمل
على كم الأفواه من جهة وإحلال ثقافة الحرية الفاسدة وفق النمط الغربي؟ متى كان
الناس والشبان وطلاب الجامعات وطلبة العلوم ال
2016-03-12